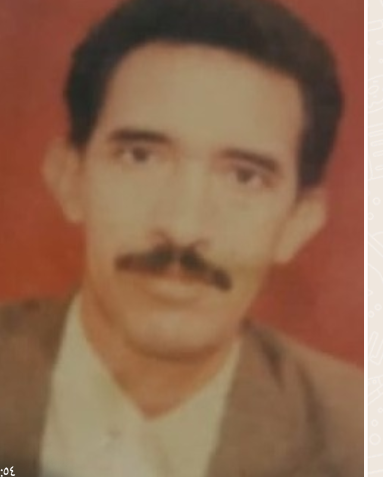
يطرح عليناعنوان المقال، السؤال التالي ماذا قصدت بالوصف، والتحليل ؟
إن البحث المنجي، كثيرا ما يقصد بالوصف لظاهرة ما، تقديمها للمشاهدين تركيزا على صفاتها الخارجية، كما يراها، أو يتصورها الواصف، والعلاقات بين عناصر الظاهرة المعبرة عن كينونتها،، بينما تحليل الظاهرة، يعنى به تقديمها على أساس من: الفهم، والتفسير، والرصد للعوامل التي أدت إلى نشأتها، وتطوها، واستمرارها، والتأثير المتبادل مع باقي الظواهر الأخرى سواء أكان ذلك في الحاضر، أم في الماضي الذي أدى الى نشأة الظاهرة، أم في المستقبل المنظور، وأي العوامل تؤثر في مجريات الاحداث، ويدخل في ذلك محاولة التنبؤ بمآلات تلك الظاهرة، موضوع الدراسة،،والى هذا الحد اسمح لنفسي بالتقصير عن تحليل الظواهر التجريدية، مراعاة لوحدة الموضوع، ومن أجل الاجابة على السؤال حول مضمون مقال الحقوقي د.احمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، حيث تساءلت في المقال السابق عن مضمون مقاله القيم، ولماذا، كان مقالا وصفيا، ولم يرجع المشاكل الاجتماعية التي عرضها،، إلى عواملها الموضوعية، كدور النظم الاجتماعية، والاحداث السياسية منذ بداية الاحتلال الفرنسي، وميراثه الذي أسماه " سارتر" بالأستعمار الجديد"، وانعكاس ذلك في مضاعفة المشاكل الاجتماعية التي اقلقته ـ احمد ولد هارون ـ وتارة اعتبرها نتائج للتسيير السياسي لنظم الحكم، وليس في ذلك ربط بين المسببات الموضوعية، والاسباب، النتائج الموصوفة التي قدمها، كمشاهد صادمة، ومهددة معا لمصير مجتمعه ـ مجتمع البيضان ـ خلال نهاية العشرية الأولى من الألفية الثالثة، غير أن الدكتور احمد ولد هارون لم يهتم بالمصطلح، ودلالته التاريخية، والعوامل التي صهرت الوحدة الاجتماعية، لمجتمعه الذي تنبأ باندثاره، وربما لم يكن من مجال تخصصه، أن مشاكل المجتمع، تدفع الى الوعي بالتحديات سواء أكان مصدها داخليا، أم خارجيا، وهذه من طبيعة الاجتماع البشري، وغاب عن ذهنه المقولة الهيجيلة التالية:" أن التاريخ أبو المعرفة "، ذلك أن لكل ظاهرة اجتماعية ابعادها التاريخية التي لا يمكن تشخيص متغيراتها الطارئة دون التعرف على تلك المرجعيات الملتبسة التي يساعد البحث في مجال علم الاجتماع التاريخي على فهم مجمل المؤثرات الخارجية بما فيها الحوادث السياسية في الحاضر الذي ركز عليه في مقاله، ويشكر على اهتمامه الحقوقي، وليسمح لنا، وكذلك القراء الكرام لإحالتهم الى بعض المصادر التاريخية التي اعتنت بتقديم معلومات مفسرة لمعنى "مجتمع البيضان"، وامتداده في التاريخ، والاستنتاج الأولي للباحث لطمأنة الجميع من جهة استعصاء المجتمعات على الاندثارالذي أشار اليه الحقوقي في آخر فقرة من مقاله ..
ف/ ابن حوقل/ وهو الرحالة العراقي الذي ألف كتابه " صورة الارض"عن رحلته ـ لمنطقتنا العربية التي نسميها الآن المغرب العربي ـ في القرن الرابع الهجري(10م)،، ولما بدأ الكتابة عن مجتمع بلادنا، استرجع ما ذكره / الكندي/، وهو فيلسوف العرب الأول، ففي" رسائل الكندي" مبحث عن تسمية كل من مجتمعي " البيضان"، و" السودان" ،، فما هو تصور هذا الفيلسوف في بعض رسائله المتعلقة بعلم الأجناس لهذين المجتمعين؟
لقد كانت اجابته واضحة، وانطلق من فرضية التفاعل بين الاجناس المختلفة، ودلالة ذلك تاريخيا، تكشف عن الوعي بالصيرورة التاريخية لكل من مجتمعي "البيضان"، والسودان"، وحضورهم في وعي هذا الفيلسوف العربي الذي كان مشرفا على" بيت الحكمة" للترجمة في بغداد،، لقد افترض في نظريته التالية: أن الاختلاط الذي كان قائما بين الاجناس ،مختلفة الألوان، المتجاورة جغرافيا على اطراف الحدود المشتركة مع المجتمعات الإفريقية المجاورة، وكان بينها تفاعل اجتماعي في إطار علاقات التزاوج بين الافراد من الطرفين المختلفين في البشرة مما أدي الى تغيير نسلهما السادس" البطن السادس" على حد تعبيره، وفي هذا اشارة الى التطور الاجتماعي عبر مئات السنين، وكان من نتائجه، هذا الوجود الاجتماعي لهذين المجتمعين " المركبين"، حيث اتخذ كل منهما اسمه، ودلالته من لونه العام، فغلبت السمرة على المجتمع المستقرعلى شواطئ البحر الاحمر، والنيل الازرق، فسمي عربيا ب"السودان"، كما غلبت الصفرة الفاتحة على المجتمع المطل على شواطئ الاطلس، واطراف الصحراء الكبرى فسمي عربيا ب"البيضان"،، والاضافة على الصفات تشير إلى متغير طارئ على الموصوف، ك"خلدون"، لخالد، و"بيضان"،لأبيض، وسودان، لأسود،،
وكانت نظرية" الكندي" في تحديد أصول الأجناس البعيدة للمجتمعين العربيين الواقعين على الاطراف النائية في الوطن العربي في افريقيا ،، أهم المعلومة الأولية التي قدمت إجابة حينها عن خصوصية الاجتماع الحضاري لكلا المجتمعين، وهو تفسير قائم على معطيات موضوعية مثل العلاقات الاجتماعية المشتركة، والتفاعل الحضاري، والموقع الجغرافي غير المنقطع عن المجال الجغرافي العربي، وعن حركة التاريخ العربي الموجهة بالتيارات الحاملة لعناصر التطور الى المراكز، والأطراف معا..
ومن هنا نتعرف على عدة حقائق، ومنها: أن "مجتمع البيضان" كان يقصد به مجتمع بلادنا منذ القرون الاولى للنهضة العربية على الأقل، وحضوره في رسائل الكندي، يؤكد أنه طان مجال تفكير في الثقافة العربية في القرن الرابع الهجري من خلال إظهار صفاته الخارجية، وعلاقته بجيرانه من الافارقة، واشقائه العرب، واخوانه البربر، وعلاقات التفاعل دون اغفال تحديد الهوية بناء على معطى اللون "بشرة" خلال الأجيال المتعاقبة، وكذلك طبيعة الاجتماع الحضاري في المدائن، التي حددها "البكري" ـ في جزء من كتابه" المسالك" ـ في ثلاثة أعراق العرب، والبربر، والأفارقة، كمكون لوحدة مجتمع مدينة " أودغست"، علاوة على ساكنة البوادي القفار على مسافة الشهر على رأي " البكري" في القرن الخامس الهجري، وهو مجتمع كانت تربطه بجيرانه علاقات ثقافية، ودينية، كالمساجد للصلاة وتعليم القرآن الكريم، والتبادل التجاري الذي اعتمد على المقايضة العينية تارة، وكذلك على الذهب: كوحدة نقدية، ولعل الأخيرة مصدر التبادل الخارجي بين المجتمع الحضري، والمجتمعات المجاورة، ولم تقتصر الطرق التجارية على المدن القريبة من مجتمع البيضان شمالا، وجنوبا، بل تجاوزتها الى مدن بعيدة،مثل مدينة "القيروان" في تونس على الرغم من بعد المسافة بينها وبين " أودغست"التي حددها " البكري" ب 110 رحلة..
ولعل المعلومات التاريخية اعلاه تطمئن الدكتور احمد ولد هارون، وغيره من الباحثين على أن مصطلح مجتمع البيضان، كان حاضرا في الذاكرة، والثقافة العالمة، ولم يرتبط بتفكك دولة السعديين، كما ذهب الى ذلك بعض الباحثين من المغرب الشقيق، ولا هو مصطلح اقترحه مؤلف فرنسي من أجل قطع العلاقات الثقافية، والاجتماعية لمجتمعنا، مع المجتمعات الشقيقة المجاورة في الشمال، والشرق، والجنوب ، ومن الأدلة على اندماجه في وحدة اجتماعية كبرى، هو تواجد جاليات منه في المجال الجغرافي لتلك المجتمعات المجاورة، رغم محافظتها على بعض الخصوصيات في المواضعات الاجتماعية، كالملبس" الدراعة"، و" الملحفة"، والسلوك الاجتماعي العام،،
ولعل مصطلح ـ مجتمع البيضان ـ أكثر توصيفا من المصطلح السابق عليه الذي أطلقه المؤرخون العرب، ك" بلاد الملثمين" الذي إلى أشار إلى ظاهرة" التكيف" مع البيئية، ب" اللثام"، كمميز بيئي، ولا يعتبر هوية سياسية، كما اشار الى ذلك الدكتور/ حسن أحمد محمود/ رحمه الله على نظام"المرابطون"، واحفادهم ـ وذلك في رسالة دكتوراه تحت عنوان" دولة المرابطين صفحات مجيدة من التاريخ" ـ وأعتقد هذا الباحث الحصيف، أن مجتمعنا في بداية الخمسينان من القرن الماضي ـ تاريخ انجازه لبحثه ـ من احفاد الملثمين على أساس تمسك افرده من الرجال ب" اللثام"، وهذا التقدير انكرته عليه في بحثي عن " النظم الاجتماعية، والثقافية على عهد المرابطين"، لأن محاولة" التكيف" مع البيئة الصحراوية، ظاهرة سلوكية لأفراد المجتمع من الرجال، وارتداء اللثام وقاء للرأس، ومنافذ الوجه،، وهو من الظاهر السابقة قبل حكم المرابطين، وقد توارثته الاجيال بعدهم، وليس من الظواهر القيمية في الوعي العام، كمميز للنظام السياسي، لذلك استبعدت اعتماده، كمحدد للهوية السياسية، فنحن هويتنا الحالية " موريتانية"، وفي المستقبل ستكون غيرها على ما أتوقع، ولا يعني في شيء التمسك بظاهرة، تشير إلى علاقة الفرد بالبيئة غير الحضرية، واعتبارها امتدادا لنظام سياسي ما، إلا إذا ارتضاها المجتمع، وثبتها، كشعار لنظامه السياسي..
وربما كان غياب الحكم السياسي في بلادنا منذ الاحتلال البرتغالي قبل خمسة قرون، مبررا لهذا التمسك بالهوية السياسية للنهضة الأولى التي استقدمها "المرابطين"، وما جرى خلال العصور التالية من ضياع الهوية، وخلال تلك الفترة، اكتسب المجتمع هوية ثقافية " الشناقطة" التي يميل الكثير الى التعريف بها بديلا عن الهوية السياسية ما لم توجد الهوية التي تعبر عن الشخصية الحضارية للمجتمع..
ومن الظواهر الذي استند إليها الدكتور حسن احمد محمود رحمه الله، أن سكان جزيرة " الكورس" الفرنسية، يعتبرون انفسهم من احفاد مجتمع الاندلس الذي كان يحكمه أمراء من المرابطين، وهاجر من الاندلس الى جهات عديدة أثناء حكم الموحدين، ك"بني غانية " في شرق الجزائر، وهناك هجرة الى جزيرة" الكورس" الإيطالية التي باعتها بسكانها، لفرنسا إثر مجاعة عامة، مقابل حمولة باخرة من القمح الذي كانت فرنسا تستقدمه من خيرات الجزائر بعد احتلالها،،
ففي زيارة قمت بها ل"متحف" في عاصمة الكورس الفرنسية في العام 2005م، وجدت سارية أمام المبنى علق عليه علم، يتوسطه رسم لرجل ملثم بلثام اسود، وهو لثام اعتمدوه شعارا لدولتهم المنتظرة بعد الاستقلال الذي يصرون عليه..
ويعتبر القائمون على المتحف أنهم احفاد "المرابطون"، والجدير بالذكر أنهم ينكرون علينا نحن الموريتانيين علاقتنا باجدادنا، ودولتهم العظيمة، ونهضتنا الأولى،، وقد استطلعوا آراء بعض المثقفين الموريتانيين،، واعتبروهم فرنسيين اكثر من الفرنسيين،، وتمنى أحد المتحدثين معي، لو حصل تبادل جغرافي معنا، ليعلنوا عن دولة مرابطية من جديد، وإن كانت برسالة مختلفة، وبعد حضاري مغاير..